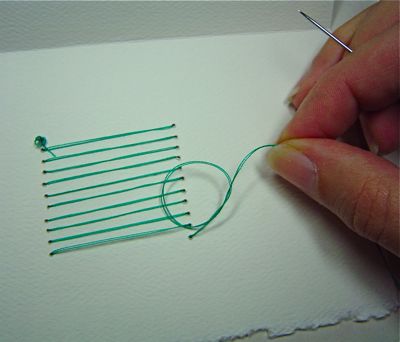ما هي ط§ظ„ط´ط®طµظٹط© ط§ظ„ط³ظٹظƒظˆط¨ط§ط«ظٹط© ، ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ عن الشخصية السيكوباثية
الشخصية السيكوباثية … السير دائما في الاتجاه المعاكس للمجتمع !

لا يعجبه شيء ويتصرف بهمجية
ربما تكون الشخصية المضادة للمجتمع أو السيكوباثية كما كانت تُعرف بالتقسيمات الخاصة بالطب النفسي سابقاً ، هي أكثر أنواع اضطراب الشخصية التي تُثير الاهتمام ، نظراً لما لهذه الشخصية من تأثير على حياة عامة الناس.
الشخصية المضادة للمجتمع ، هي الشخصية التي تبدأ في التبلور من سن مبكرة قد يكون سن الطفولة أو بداية المراهقة ، و تكون عبارة عن أفعال مضادة للمجتمع سواء كانت سلوكيات إجرامية تتناسب مع العمر للشخص الذي يُعاني من هذا الاضطراب في الشخصية وتستمر في اختلال هذا الشخص في الحياة بوجهٍ عام ، حيث تؤثر على مختلف مناحي حياة هذا الشخص ، العملية ، الزوجية ، الاجتماعية ، الدراسية.
في بداية القرن التاسع عشر (عام 1801) قام أحد العلماء (فيليب بينيل) بوصف هذا النوع من الشخصيات بأنهم منُدفعون ، ليس لديهم مشاعر و يقومون بأفعال عديمة المسؤولية تصل إلى جرائم كبيرة مثل القتل ، ولكن نسبة ذكائهم وقدرتهم على الحكم على الأمور وقدراتهم العقلية و ذاكرتهم ليس بها أي مشكلة.
بعد ذلك تحدّث الكثير من العلماء والأطباء النفسيين عن اضطراب الشخصية السيكوباثية والذي سُمي فيما بعد باضطراب الشخصية المضاد للمجتمع.
ما كُتب في القرن التاسع عشر بعد ذلك كان مُشوشاً أكثر منه موضحاً لطبيعة اضطراب الشخصية السيكوباثية. فبعض العلماء ربطوا السلوكيات العدوانية والإجرامية للشخص الذي يُعاني من اضطراب الشخصية السيكوباثية ( الشخصية المضادة للمجتمع ) ، وكان أول شخص يستخدم مصطلح الشخصية السيكوباثية هو كوش (Koch) عام 1891م.
استمر يُطلق الشخصية السيكوباثية على هذا الاضطراب من اضطرابات الشخصية حتى فترة قريبة ، عندما تم تغيير التسمية إلى الشخصية المضادة للمجتمع.
الشخص الذي يُعاني من هذا الاضطراب ، والذي يبدأ عنده عادةً في مرحلة الطفولة أو بداية المراهقة كما ذكرنا ، يكون في بداية حياته الدراسية مُسبباً لكثير من المشاكل مع زملائه وكذلك مع المعلمين. يكون الطالب كثير المشاكل ، مثل سلوكيات عدوانية تجاه زملائه الطلاب ويفتعل المشاكل مع المعلمين. يكون طالباً مشاغباً في الفصل ، وربما يكون مُهاب الجانب عند زملائه الطلاب ، وهذا قد يجعله محط إعجاب لبعض الطلبة ، وهذا يقوده للاستمراء و التمادي في مشاكله وسلوكياته العدوانية. هذا السلوك يختلف عن سلوك الطالب المشاغب العادي ، الذي يقوم ببعض السلوكيات غير المرغوب بها. هذا الطفل الذي لا يُعاني من اضطراب في شخصيته تكون سلوكياته محدودة ولا تستمر لفتراتٍ طويلة ، وينفع معه العقاب والتعاملات السلوكية فيصبح سلوكه مقبولاً و يتغيّر إلى الأفضل.
الطفل الذي يكون في بداية تكوين شخصيته المضادة للمجتمع ، لا ينفع معه العقاب ولا التعامل السلوكي بل يزيده تمادياً في سلوكياته العدوانية. بالطبع لا يمكن إطلاق صفة الشخص الذي يُعاني من اضطراب الشخصية ضد المجتمع من سن الطفولة لأنه لا يجوز تصنيف الطفل أو المراهق بأنه يُعاني من الاضطرابات الشخصية قبل سن الثامنة عشرة ، لكن يجب أخذ هذه السلوكيات من سن الطفولة والمراهقة خاصة بعد سن الخامسة عشرة إلى أن يصل إلى سن النضج وتتضح بصورةٍ أكثر سلوكياته في جميع مناحي حياته.
كيف تنتبه العائلة إلى أن ابنها لديه مشكلة اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع.
في بداية حياته يكون الطفل كما ذكرنا لديه ميول عدوانية وتستمر هذه السلوكيات العدوانية لسنوات عديدة و يكون هناك تخريب لممتلكات عامة في المدرسة أو في الحي أو يعتدي على ممتلكات خاصة مما قد يُعرّضه لمشاكل مع المسؤولين في المدرسة أو مع الجهات الأمنية أو القانونية. كثيرا ما يتعاطى الأشخاص الذين يُعانون من اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع المخدرات أو أحياناً يتاجرون في المخدرات مما قد يسبب لهم مشاكل كثيرة مع الأنظمة والقوانين و كثيراً ما يقضون فترات من حياتهم في السجون.
ليس هناك أسباب محددة لاضطراب الشخصية المضادة للمجتمع ، و إن كان هناك بعض الدراسات تُشير إلى أن هناك دوراً للوراثة في هذا الأمر.
الجمعية الأمريكية للطب النفسي ، في تصنيفها الطبعة الرابعة ( المراجعة ) ، وضعت خصائص يجب توفّرها لكي يتم تشخيص المرء بأن يُعاني من الاضطراب الشخصية المضادة للمجتمع ( الشخصية السيكوباثية):
1- أن يكون الشخص لدية عدم احترام للآخرين و حرياتهم والاعتداءات على الآخرين و يبدأ هذا من سن الخامسة عشرة ، ويُكون ذلك بوجود ثلاثة من الأمور التالية:
أ.الفشل في التصرف بشكل طبيعي بالنسبة للسلوكيات المعتادة ، ويقوم المرء بأعمال تستوجب القاء القبض عليهم من قِبل السلطات الأمنية والقانونية.
ب. القيام بخداع وكذب متكرر واستخدام هذه السلوكيات لمكاسب شخصية للفرد الذي يُعاني من هذا الاضطراب في الشخصية
ت. الاندفاعية وعدم القدرة على السيطرة على السلوكيات الاندفاعية وعدم القدرة على التخطيط للمستقبل.
ث.التوتر والعدوانية و يظهر ذلك في الاعتداءات البدنية المتكررة على الآخرين ومهاجمة الابرياء.
ج.الهمجية وعدم التقيد بأنظمة الأمان للشخص نفسه وللآخرين.
ح. عدم المسؤولية الدائمة والمستمرة للشخص ويظهر ذلك من خلال الفشل المتكرر في الاحتفاظ بعمل شريف أو الاحتفاط بعمليات مالية نزيهة.
خ. عدم الندم على الأخطاء التي قام بها الشخص و يظهر ذلك جلياً في عدم اهتمامه بمشاعر الاشخاص الذين اعتدى عليهم أو أساء معاملتهم أو سرق منهم أغراضهم.
2- عمر الشخص على الأقل هو 18 عاماً.
3- هناك دلائل على مشاكل سلوكية شرسة قبل أن يصل إلى سن الخامسة عشرة.
4- السلوكيات العدوانية والأجرامية ليست نتيجة الأصابة بمرض الفُصام أو الاضطراب الوجداني ، خاصة نوبة الهوس.
نسبة الإصابة بهذا الاضطراب ( اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع ) تصل إلى حوالي 3% بين الرجال و 1% بين النساء ، هذه الدراسة في المجتمع. في الدراسات في المستشفيات تتراوح النسبة ما بين 3% إلى 30%.
مآل الاضطراب هو أنه اضطراب مزمن ولكنه يخف مع الزمن والتقدم في العمر ، خاصة بعد عمر الخامسة والاربعين. ويخف كلما تقدّم الشخص في العمر ، ويقل السلوك الإجرامي مع التقدم في العمر ولا يقوم الشخص بعد تقدمه في العمر بأي جرائم كما يحدث عندما كان في سن الشباب ، ولكن قد يكون تورّط في قضايا وجرائم من سن مبكرة ، وربما أبقته في السجن لسنوات طويلة إذا أرتكب جريمة كبيرة فيبقى في السجن وهو في سنٍ متقدم.
الوراثة والإصابة بهذا الاضطراب في الشخصية تكون أكثر بين الأقارب من الدرجة الأولى مقارنة بعامة الناس ، حيث إن الإصابة بين اقارب المرأة التي تعاني من اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع أعلى من أقارب الرجل المصاب باضطراب الشخصية المضادة للمجتمع. أقارب الاشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية ربما يعانون من اضطرابات التجسد ( المعاناة من اضطرابات عضوية بسبب أسباب نفسية ) كذلك يمكن أن يكونوا أكثر قابلية لتعاطي المخدرات. داخل عائلة الرجل الذي يُعاني من اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع ( الشخصية السيكوباثية ) يكون هناك أستخدام أكثر للمخدرات و الأمور المتعلقة بتعاطي المخدرات.
يعاني الاشخاص الذين لديهم اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع من تضخم الذات، عدم الاهتمام بمشاعر الآخرين ، يرون أنفسهم أعلى من العمل في الوظائف الوضيعة برغم عدم تعلّمهم أو حصولهم على أي شهادات. ليس لديهم واقعية في سلوكياتهم في الحياة ، ويستخدمون العنف لحل ما يعترضهم من مشاكل ، وليس لديهم تخطيط للمستقبل وحتى لو وضعوا خططاً للمستقبل فإنهم لا ينجحون في اتباع هذه الخطط المستقبلية. يتعاملون مع الآخرين بتعالٍ و يستخدمون العنف المُبالغ به لتحقيق أغراضهم من الآخرين. بعض هؤلاء الاشخاص الذين يُعانون من اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع ، يحاولون خداع الآخرين ويكونون في غاية اللطف ، الذي يصطنعونه و يتحدثون بلغةٍ راقية ، وبالفعل يستطيعون الكذب والخداع على من لا يعرف هذا الاضطراب ، وقد يخدعونهم في علميات نصب واحتيال مالية قد تكون في مبالغ كبيرة ، وليس بعيداً أن يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص الذين يصطنعون اللطف والكياسة في بداية الأمر أن يستخدموا العنف لإكمال عمليات النصب والخداع التي بدأوا بها بهدوء و لطف ولكن طبيعتهم العنيفة لا يتخلون عنها. ونظراً لأنهم لا يحسون بالندم على أي أذى يُلحقونه بالآخرين فإنهم يستغلون طبيعتهم وما تطبّعوا عليه في تعاملهم مع الآخرين.
اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع يكون أكثر في الأوساط الاجتماعية الأكثر فقراً وفي المدن ، خاصة أواسط المدن المكتظة بالسكان.
خلال حياتي العملية ، اجد أن هؤلاء الاشخاص الذين يُعانون من اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع ( الشخصية السيكوباثية ) ، من أصعب الاشخاص الذين يتعامل معهم الطبيب النفسي ، حيث إنه لا يوجد علاج ناجع معهم ، اضافة أنهم قد يُشكلون خطراً على المعالج الذي يتعالجون عنده ، سواءً كان طبيباً نفسياً أو معالجاً نفسياً. للأسف لم تفد العلاجات النفسية بالأدوية ولا العلاجات النفسية بالعلاج النفسي ، سواءً كان التحليل النفسي ، حيث أجريت دراسة على شخص يُعاني من الشخصية المضادة للمجتمع لمدة سبع سنوات بعلاجه عن طريق التحليل النفسي ولكن في نهاية السبع سنوات لم يكن هناك أي تحسن يذكر في حالة هذا المريض. الأدوية تم تجريب أنواع كثير من مثبتات المزاج ولكن لم تكن هناك أي فائدة من استخدام هذه الأدوية ، لذلك فإنه من المُحبط للطبيب أو للمعالج النفسي أن يتعامل مع مثل هذه الحالات التي لا يُعالجها إلا الزمن .
قد يشعر بعض القراء بالإحباط من هذا الاضطراب ولكن هذه هي الحقيقة ، فمن نقاط ضعف الطب النفسي هو عدم إيجاد حل وعلاج لاضطرابات الشخصية على وجه العموم. ويُشكّل اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع ( الشخصية السيكوباثية) واحداً من أكثر الصعوبات التي تواجه الأسرة والمجتمع نظراً لخطورة ما يقوم به الشخص الذي يُعاني من هذه الشخصية التي قد تُسبب مشاكل كثيرة للمجتمع وقبل ذلك للأسرة التي تعاني كثيراً من أحد أفرادها الذين يُعانون من هذا الاضطراب الصعب في الشخصية.
جريدة الرياض
مشكورة غلاتي