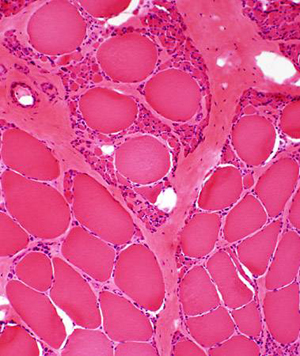مقدمة:
التعليم كحق من حقوق الإنسان يعتبر شرط للتمتع بحقوق اخري فهو مقدمة لابد منها ليعرف الإنسان حقوقه، يفهم هذا المعني سواء من الجانب الحقوقي بداية من العهد الولي لحقوق الإنسان 1948 ، أو من الجانب التربوي والذي يعني بالجانب السلوكي الاجتماعي للإنسان، ومع هذا الوضوح الشديد للتعليم كحق جوهري لكل إنسان، إلا الأمر ليس كذلك بالنسبة لفئات اجتماعية عديدة يأتي بمقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد حرم ذو الإعاقة فعليا من التعليم نتيجة وصمهم بالعجز على مر التاريخ، والحقيقة أن القلة من ذوي الإعاقة الذين مارسوا الحق بالتعليم حتى التعليم العالي قد ساعدتهم ظروف عديدة من أهمها توفر الإمكانيات المالية، ففي قلة من المدارس الخاصة التي تقدم إقامة فندقية وتوفر نخبة من المعلمين المتخصصين، وبمبان ومنشئات مصممة طبقا لأحدث التصميمات الخاصة بذوي الإعاقة، يحصل أبناء الأسر الغنية على مستوي تعليمي متقدم يفوق من حيث الجودة مستوي التعليم الرسمي، والحقيقة أن هذا المستوي من التعليم له جانبه السلبي وجانبه الإيجابي، فهو يثبت بما لا يدع مجال للشك أن لذوي الإعاقة قدرة على التعلم مع الاختلاف الطبيعي عن الآخرين، لكن هذا المستوي المكلف جدا يستبعد تلقائيا الغالبية الكاسحة من الأطفال ذوي الإعاقة الفقراء والذين تزيد نسبتهم عن 90 % من تعدد ذوي الإعاقة بالعالم طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.
إن هذا التقرير يهدف إلي رصد مدي ممارسة ذوي الإعاقة لحق التعليم بمصر من منظور حقوقي، ويعني ذلك أن التقرير يعتمد على المرجعية الدولية كمصدر تاريخي " نظري " وعلى المعلومات المتوفرة عن تعليم ذوي الإعاقة بمعني انخراطهم بالنظام التعليمي الرسمي كمصدر ميداني، ويبقي أن نشير إلي التلاحم بين حق ذوي الإعاقة في التعليم وحقهم في التأهيل، فالتعليم بالنسبة لذوي الإعاقة يبدأ مبكرا جدا فهو جزء من عملية التأهيل، وسوف يتعمد هذا التقرير الفصل بين الحقين على مستوي الرصد ويعني ذلك أن المقصود بتعليم ذوي الإعاقة هو انخراطهم بالنظام التعليمي الرسمي.
ماهية الحق في التعليم:
من الصعب أن نجد تعريف محدد للحق في التعليم، فهو حق متعدد الجوانب منها، المعرفي، التربوي، الحقوقي، السلوكي، ولغياب التعريف المحدد سوف نعتمد على الماهية الحقوقية للتعليم، وبالتأكيد هي المستخلصة من المواثيق الحقوقية التي نصت على الحق في التعليم، والتعليم من الجانب الحقوقي يعني ( هو الأداة الأساسية لإيقاظ القيم الثقافية في الطفل وكذلك لتحضيره للتدريب المستقبلي و مساعدته في التوافق مع بيئته بشكل طبيعي ) 1
عناصر الحق في التعليم:
ورد الحق بالتعليم بعدد من المواثيق الحقوقية، بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " مادة 26 " ومرورا بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادة " 13 " واتفاقية مناهضة التميز بالتعليم، وانتهاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد قننت
تلك المواثيق الحق كما حددت عناصره المختلفة وهي:
o المجانية، وتعني أن لكل إنسان التمتع بالحق دون أن يتحمل تكاليف مادية. " مادة 26 1 من العهد الدولي " / الإعلان العالمي – مادة 13
o الإلزام، ويعني ذلك أنه حق ملزم للطرفين وليس من حق الشخص رفض التعليم بالمرحلة الأساسية.
o تكافؤ الفرص، والمقصود تساوي فرص الجميع للالتحاق بالتعليم الجامعي على أساس الكفاءة فقط.
o حق ولي الأمر في اختيار نوع التعليم.
أهداف إعمال الحق في التعليم:
1 – إنماء شخصية الإنسان على كل المستويات.
2 – تعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان.
3 – تمكين الشخص اجتماعيا وتيسير المشاركة الفاعلة في شئون المجتمع.
2 العهد الدولي " / 4 – احترام الثقافات الخاصة. " مادة 13
4 العهد الدولي " / 5 – المساواة وعدم التمييز. " مادة 13
معايير ممارسة الحق في التعليم:
هناك معايير عديدة لقياس التعليم منها التربوي، ومنها الخاص بجودة العملية التعليمية، وتوجد نظريات عديدة لمعايير التعليم الجيد، تتفق كلها على المحددات الجوهرية " المعلم – المنهج – المدرسة ) وتختلف في التفصيلات وأدوات القياس، وسوف نعتمد هنا على " معايير حقوقية " وهي الواردة بالتعليق العام رقم 13 ( الحق في التعليم 1999 ) الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد وضع هذا التعليق أربعة معايير لقياس مدي
ممارسة حق التعليم وهي:
أولا: التوفر
والمقصود هو توفر البنية المادية اللازمة لممارسة التعليم ( مباني – مرافق صحية – مياه شرب – مواد تدريس ) كذلك توفر الكوادر البشرية من المعلمين المدربين.
ثانيا: إمكانية الالتحاق " الإتاحة "
ويعني تيسير الالتحاق بالمدارس للجميع دون تمييز لأي سبب.
ثالثا: إمكانية القبول " الملائمة "
والمقصود أن يكون التعليم من حيث الشكل والمضمون مقبول ووثيق الصلة بالاحتياجات وملائما من الناحية الثقافية وخاضعا لمعايير الجودة.
رابعا____________: التكيف
والمقصود هنا تمتع النظام التعليمي والسياسات التعليمية بالمرونة اللازمة للاستجابة لاحتياجات الطلاب بمحيطهم الثقافي المتنوع.
ماهية حق ذوي الإعاقة في التعليم:
حتى وقت قريب لم يكن حق ذوي الإعاقة في التعليم محدد بوضوح ومنصوص عليه بالتفصيل بالمواثيق الدولية، فالتمييز تجاه ذوي الإعاقة كان دائما يجد ما يبرره نتيجة الوص بالعجز الذي مازال ملتصق بذوي الإعاقة، أي أن السياسات التعليمية كانت تنطلق من كون الشخص ذو الإعاقة غير قادر على ممارسة هذا الحق بشكل كامل مثله في ذلك مثل كل إنسان، وبدأ هذا الوضع يتغير خلال العقدين الآخرين بشكل ملحوظ على المستوي النظري مستفيدا من محاولات بسيطة لدمج ذوي الإعاقة في التعليم، ويمكن اعتبار المادة " 23 " من اتفاقية حقوق الطفل، أول اعتراف واضح بحق الطفل ذو الإعاقة في التعليم أيا كانت إصابته، وقد فصلت أخيرا الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هذا الحق بالمادة 24 منها، وتؤكد المادة بداية على حق ذوي الإعاقة في تعليم جامع على جميع المستويات، ثم تورد المادة التفاصيل الخاصة بذوي الإعاقة لممارسة الحق، ويمكن تفصيل المادة على النحو التالي:
أهداف التعليم:
– كفالة التعليم الجامع.
– تعزيز احترام الحقوق والتنوع البشري.
– تنمية القدرات العقلية والبدنية والمواهب لأقصي مدي.
– التمكين من المشاركة الفاعلة بالمجتمع.
" مادة 24 فقرة أ، ب، ج "
التزامات الدولة:
– عدم الاستبعاد على أساس الإعاقة.
– التيسير والدعم.
– مراعاة الاحتياجات الفردية.
– توفير المستلزمات الخاصة.
" 3 ، " مادة 24 فقرة 2
والحقيقة أن تفاصيل هذه المادة لا يمكن فهمها إلا في سياق نظرية " الدمج في التعليم " وهي منهجية شاملة للتعليم، ويصعب عرض هذه المنهجية بشكل وافي بهذا التقرير، وسنكتفي هنا بعرض للمفهوم على أن نناقش نظرية الدمج بدراسة خاصة.
مفهوم التعليم الجامع – نظرية الدمج في التعليم
يرتكز تطوير تعليم ذوي الإعاقة خلال العقدين الأخيرين على نظرية الدمج في التعليم، وهي النظرية التي بدأ تطبيقها بالولايات المتحدة الأمريكية بعهد " جون كنيدي ". 1975 . وبسرعة كبيرة تبني المدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة تلك النظرية بشكل كامل حتى أصبح الحديث عن تعليم ذوي الإعاقة يعني دمجهم بالنظام التعليمي، وببساطة يعني التعليم الجامع، أن يلتحق كل طفل بالنظام التعليمي الرسمي دون أي تفرقة من أي نوع وخاصة الإعاقة، وبمعني أكثر دقة هو التعليم للجميع.
والهدف العام للتعليم الجامع هو ( دعم التعليم للجميع مع التركيز الخاص على إزالة الحواجز التي تعوق المشاركة والتعليم بالنسبة للمرأة والجماعات المحرومة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال خارج المدرسة ) 2 ومن الجانب الحقوقي يفهم الدمج بمقابل العزل . والاستبعاد بسبب الإعاقة. 3 وعلى ذلك يمكن تعريف حق ذوي الإعاقة في التعليم بأنه " الحق في فرص متساوية م ع الجميع في الاستفادة من النظام التعليمي الرسمي وبنفس المنشآت التعليمية وبما يتناسب مع
الاختلافات بينهم وبين غيرهم، وإزالة الحواجز المادية والإدارية والثقافية التي تحول بينهم وبين ممارسة الحق "
حق ذوي الإعاقة في التعليم بالقوانين العربية:
تتبني غالبية البلاد العربية مفاهيم الدمج على المستوي النظري، وقد تم التأكيد على ذلك 2024 ) والذي نص على – بالمحور الثاني من ( العقد العربي للمعاقين 2024
( ضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المعاقين ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية وفي صفوف خاصة إذا استدعى الأمر. ولتحقيق ذلك يسعى العقد الى :
توفير الكوادر التربوية والتعليمية المؤهلة لتربية وتعليم الأطفال المعاقين ضمن سياسة الدمج. توفير الوسائل والمعينات التي تسهل العملية التربوية والتعليمية.
توعية الأسرة والمجتمع بأهمية دمج الأطفال المعاقين في المدارس العادية وتأهيل الأطفال والمدرسين لاستقبال الأطفال المعاقين.
إعادة النظر في البناء المنهجي للبرامج التعليمية لتتلاءم مع السمات الإنمائية والنفسية للأشخاص المعاقين وروح العصر والتطور التكنولوجي.)
وواقعيا تتباين القوانين العربية الخاصة بالإعاقة بخصوص حق التعليم، ويمكن تقسيم تلك القوانين لقسمين أساسيين:
الأول: يكتفي بالتأكيد على حق ذوي الإعاقة في الدمج في التعليم بشكل أساسي، وإحالة التفاصيل الخاصة بممارسة الحق إلي جهة رسمية تتولي وضع السياسات ومتابعة التنفيذ، ومن أمثلة هذا النوع، القانون اليمني " مادة 12 " وكذلك القانون السعودي " مادة 37 " ونجد سمات أساسية بين هذه القوانين:
o النص على الدمج بمراحل التعليم العام.
o تولي جهة رسمية إعداد المناهج ومتابعة التطوير " مادة 9 القانون اليمني "
o المزج بين التأهيل والتعليم " مادة 10 القانون التونسي – مادة 12 لائحة القانون اليمني "
القسم الثاني: ويضم القوانين الأكثر تقدما، حيث تتناول النص على الحق بالتفصيل والتأكيد على مناهضة التمييز، والحقيقة ليس هناك سوي القانونين الفلسطيني واللبناني الذي يتبني منهجية حقوقية واضحة وعميقة، ولو طالعنا القانون اللبناني كمثال سنجده يتبني مفاهيم الدمج بشكل أكثر وضوحا، ويتميز القانون اللبناني ب:
" o التأكيد على حق التعليم بدلالة حقوقية واضحة " مادة 59
– o التأكيد على مناهضة التمييز بسبب الإعاقة والنص على تكافؤ الفرص " مادة 59 " مادة 60 " 62 ،61، o منح ميزات لذوي الإعاقة وإزاحة الحواجز الإدارية والقانونية" مادة 60
o الربط بين الحق والتوعية والمعرفة به " مادة 64 " والتي نصت على إدراج حقوق ذوي الإعاقة بمناهج التعليم العامة.
تعليم ذوي الإعاقة في القانون المصري:
برغم التبني الرسمي لنظرية الدمج في التعليم إلا أن القانون المصري مازال يقوم على مفاهيم التعليم الخاص، حيث تنص المادة التاسعة من قانون التعليم رقم " 139 لسنة 1981 " على ( لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم علي أن يتضمن قرار ألإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.)
وطبقا لهذا القانون توجد إدارة تعليمية مركزية خاصة هي " إدارة التربية الخاصة " تتفرع لثلاث إدارات فرعية هي ( إدارة التربية البصرية – إدارة التربية السمعية – إدارة التربية الفكرية ) وتختص كل إدارة فرعية بنوع محدد من المدارس وقد صدرت قرارات وزارية عديدة لتنظيم هذه المدارس أهمها القرار رقم 37 لسنة 1990 شروط القبول بمدارس التربية الخاصة، وطبقا لهذا التقسيم القانوني توجد ثلاث أنواع من المدارس هي:
أولا: مدارس التربية الفكرية:
وهي كما عرفها القانون ( المدارس التي تقوم بتعليم المعاقين عقليا ) وشروط القبول بتلك المدارس:
-1 أن تكون نسبة الذكاء ما بين 50 إلي 75 درجة.
-2 عدم وجود إعاقة أخري.
-3 الاستقرار النفسي.
-4 أن لا يقل العمر الزمني عن 6 سنوات ولا يزيد عن 12 سنة.
وتقوم الدراسة بهذه المدارس على ثلاث مراحل هي، التهيئة، المرحلة الابتدائية ، والتعليم المهني.
ثانيا: مدارس التربية البصرية
يوجد نوعان من مدارس التربية البصرية، الأول خاص بفاقدي البصر، والثاني خاص بالمصابين بضعف البصر، والفرق بين النوعين يعود لاختلاف الأدوات المستخدمة لتيسير التعلم، حيث يستخدم النوع الثاني أدوات تستفيد من الجزء المتبقي من قوة الإبصار:
شروط الالتحاق:
8 سنوات للقبول بالمرحلة الابتدائية. – -1 السن من 6
60 / -2 أن يكون الطفل فاقد للبصر كليا أو تقل حدة أبصارهم عن 6
-3 عدم وجود إعاقة أخري.
شروط الالتحاق بمدارس المحافظة على البصر:
. 60 / 24 و 6 / -1 أن تكون حدة الإبصار محصورة بين 6
-2 عدم وجود إعاقة أخري جسمية، أو حسية، أو ذهنية.
ثالثا: مدارس التربية السمعية:
تشمل مدارس التربية السمعية نوعين، الأول مخصص لفاقدي حاسة السمع، والثا ني خاص بالمصابين بضعف السمع الشديد:
شروط القبول بمدارس فاقدي السمع:
7 سنوات. – -1 السن من 5
6 ديسبل بالنسبة – 12 ديسبل، وما بين 5 – -2 تتراوح نسبة عتبة السمع ما بين 7
لضعاف السمع.
-3 عدم وجود إعاقة أخري.
وتستمر الدراسة بتلك المدارس لمدة ثماني سنوات مع التركيز على التعليم المهني. من الواضح جدا التخلف الشديد لهذا القانون والقرارات المنظمة له، حيث يقوم على التصنيف والعزل، ومن المنطقي أن يشمل تمييز واضح بسبب الإعاقة، مثل شروط القبول التي تستبعد
متعددي الإعاقة لتحرمهم جميعا من ممارسة حق التعليم، والحقيقة أن المسافة الشاسعة بين القانون وبين السياسة الرسمية المعلنة لوزارة التربية والتعليم " الخطة الإستراتيجية للدمج " تعني أن التطوير المعلن عنه يتم بمعزل عن القانون، وهو وضع عبثي بالنسبة لأي مجتمع يدعي التحديث، فخطة الدمج تسير جنبا إلي جنب مع كيانات إدارية وفنية تقوم على التصنيف والعزل.
وضع تعليم ذوي الإعاقة بمصر
في ظل التناقض الكبير بين النظام القائم لتعليم ذوي الإعاقة بمصر وبين الرؤية الحقوقية القائمة على الدمج ورفض التمييز، سوف يعتمد هذا التقرير على تقييم حالة ممارسة ذوي الإعاقة للحق من خلال المعلومات الرسمية المتوفرة طبقا للتصنيف الرسمي للإعاقات، وسوف نقيس الوضع القائم على أساس المعايير الأربعة الواردة بالتعليق العام رقم 13 والسابق الإشارة إليه:
-1 معيار التوفر:
أولا: مدارس التربية الفكرية:
عدد المدارس 468
عدد الفصول 2101
عدد الإناث 6193
إجمالي عدد التلاميذ 19340
ثانيا: مدارس التربية البصرية:
عدد المدارس 89 مدرسة
رياض أطفال 6
ابتدائي 28
اعدادي 28
ثانوي 25
وتتوزع تلك المدارس على المحافظات المختلفة حيث تضم القاهرة 6 مدارس، الإسكندرية 2
، ومدرسة واحدة بكل محافظة عدا خمس محافظات هي البحر الأحمر، الوادي الج ديد،
حلوان، جنوب سيناء، السادس من أكتوبر.
ثالثا: مدارس التربية السمعية:
عدد المدارس 232
عدد الفصول 1445
عدد الإناث 6171
إجمالي عدد التلاميذ 14689
مجمل مدارس إدارة التربية الخاصة:
المرحلة التعليمية عدد المدراس عدد الفصول عدد التلاميذ
ما قبل الابتدائي 9 88 14
الابتدائي 24577 2916 497
الاعدادي العام 525. 82 30
الاعدادي المهني 3272 271 71
الثانوي العام 717 88 25
الثانوي الفني 3154 239 54
المجموع 36070 4022 808
مجمل المعلمين بالتربية الخاصة:
عدد مدرسين التربية الخاصة / مدرسة / المجموع / النسبة
%57.4 8447 4848 3599
الحقيقة أن تلك الجداول تكشف عن إشكالية كبيرة طبقا لمعيار " التوفر " فالعدد الإجمالي لعدد التلاميذ بمدارس التربية الخاصة مجتمعة على مستوي الجمهورية يزيد قليلا عن 3600 وهو رقم لا يقارن بأقل التقديرات الخاصة بذوي الإعاقة حتى لو أضفنا له 2024 تلميذ من المفترض أن تشملهم خطة الدمج فيكون المجموع 65000 تلميذ، فلوا قسنا على تقديرات منظمة الصحة العالمية، فعدد ذوي الإعاقة بمصر يقترب من 8 مليون شخص، وطيقا للتقسيم العمري للسكان سنفترض – طبقا لأقل تقدير – أن لدينا مليون طفل من ذوي الإعاقة بمصر
.% ، بسن التعليم، ومعني ذلك أن من يمارس الحق بالتعليم فعليا أقل من 5
-2 الإتاحة:
ذكرنا أن معيار الإتاحة يعني " شمول النظام التعليمي للجميع دون تمييز " ولو استقرائنا ظاهر الوضع القانوني والإداري لسياسة التعليم الخاص بذوي الإعاقة سنجد التمييز ضدهم بوضوح، فهناك فئات مستبعدة أصلا بحكم القانون ( متعددي الإعاقة – مصابي التوحد ) فالتعليم الرسمي غير متاح سوي لثلاث فئات فقط ( ذوي الإعاقة السمعية – ذوي الإعاقة البصرية – ذوي الإعاقة الذهنية الذين تتراوح نسب ذكائهم بين 50 إلي 75 درجة ).
القبول " الملائمة "
أكدت الكثير من الدراسات الحديثة التي أجريت على مدارس التربية الخاصة على تردي وضع التعليم بمدارس التربية الخاصة بشكل عام من حيث:
o عدم تغطية خدمات التربية الخاصة إلا لنسبة ضئيلة من المستحقين. 3
o ضعف إمكانيات الأبنية وما تشمله من فصول، ور ش، حجرات، وعدم كفاية التجهيزات، وغياب المعايير الصحية للأبنية. 4 كما أكدت دراسة ميدانية هامة طبقت على مدارس التربية الفكرية بمحافظة سوهاج على غياب المفاهيم الحديثة للتربية الفكرية، وضعف المناهج وجمودها، غياب الشروط والمواصفات البنائية والنقص الحاد في المدرسين المدربين. 5
-3 التكيف:
من المؤكد أن السياسة التعليمية القائمة تجاه ذوي الإعاقة تعاني من جمود، فالتقسيم الإداري والفني نفسه يتناقض مع المفاهيم الحديثة التي سادت خلال العقدين الأخيرين، ومن المستحيل منطقيا أن النظام القائم يتماشي مع التطورات الحديثة، والحقيقة أن المقارنة بين بعض المدارس الخاصة ذات التكلفة المرتفعة جدا وبين المدارس الرسمية تبدو ظالمة جدا بالنسبة للمدارس الرسمية.
نتائج:
أولا: أن السياسة التعليمية الحالية تقوم على عزل ذوي الإعاقة وإقصائهم عن المجتمع.
ثانيا: تنتهك السياسة الحالية حق فئات عديدة من ذوي الإعاقة في التعليم.
ثالثا: البنية المادية القائمة لمدارس التربية الخاصة لا تكفي سوي لأقل من 5، % من ذوي الإعاقة.
رابعا: وجود شروط وحواجز ثقافية وإدارية تحول بين غالبية ذوي الإعاقة وبين ممارسة حق التعليم.
خامسا: النقص الحاد بالكوادر التعليمية المدربة ( معلمين – مساعدين – أخصائيين ).
المصادر:
A Parent’s Guide for Special Education -1
Website of disability rights education and defense fund
2 – الحق في التعليم للجميع.. رؤية عالمية للتعليم الجامع..جيل فان ديل ..اليونسكو
-3 أحمد جابر أحمد وخالد عواد صابر، 2024 م"
-4 أسماء على مصيلحى، 2024
5 – تطوير مدارس التربية الفكرية بمحافظة سوهاج – دراسة ميدانية " د/ عماد صموائيل
وهبة "
6 – موقع إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم على شبكة المعلومات.
7 – موقع الهيئة العامة للاستعلامات على شبكة المعلومات.



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)